العقيدة-وأهمّيّتها
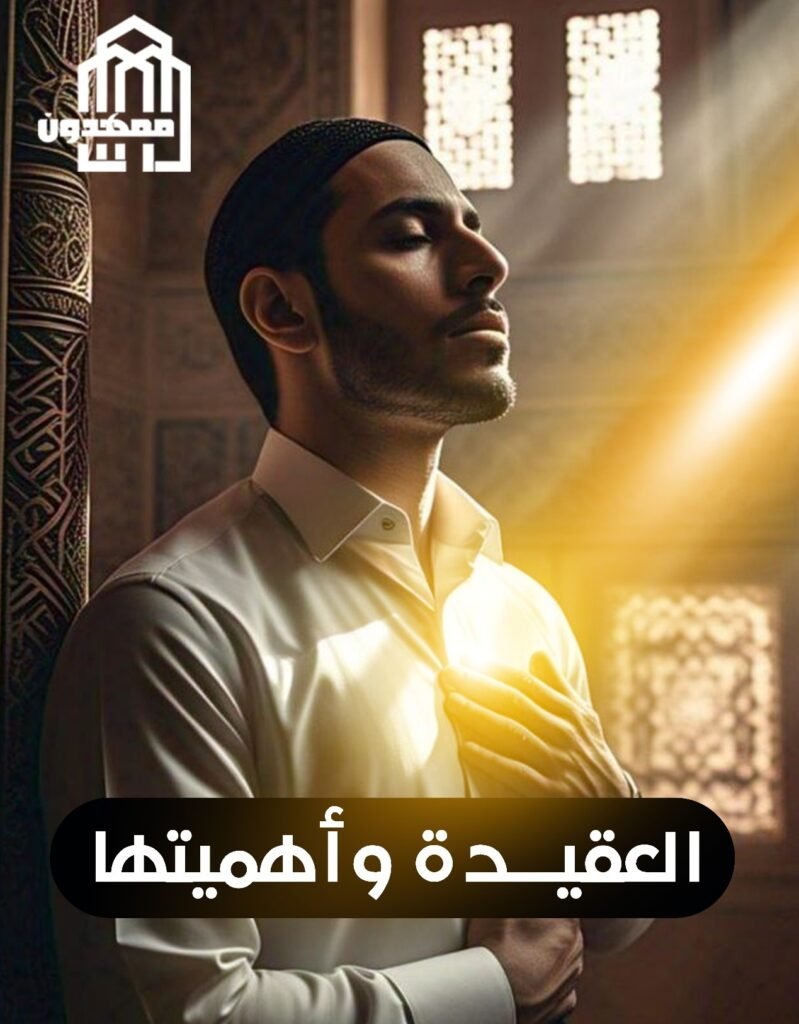
العقيدة وأهمّيّتها.
العقيدة: هي مجموعة الأفكار الأساسيّة عن الكون وما فيه من حيث وجوده ومنتهاه والخالق وصفاته وعلاقته بخلقه.
موضوع العقيدة: البحث عن الخالق تعالى، وصفاته، وعدله، ونبوّة نبيّنا محمّد (صلى الله عليه وآله) والأوصياء من بعده (عليهم السلام)، والمعاد يوم القيامة، وما يرتبط بذلك.
العقيدة في الكتاب والسنّة
ورد الحثّ الأكيد في القرآن الكريم والسنة الشريفة على التفكّر في خلق السماوات والأرض في آيات كثيرة منها:
- قوله تعالى: ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وٱلۡأَرۡضِ رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَٰذَا بَٰطِلٗا سُبۡحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾[i].
- وقوله سبحانه: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلۡإِبِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ ١٧ وإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيۡفَ رُفِعَتۡ ١٨ وإِلَى ٱلۡجِبَالِ كَيۡفَ نُصِبَتۡ ١٩ وإِلَى ٱلۡأَرۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ ٢٠ فَذَكِّرۡ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٞ ﴾[ii].
- وقوله جلّ جلاله: ﴿ إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وٱلۡأَرۡضِ وٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وٱلنَّهَارِ وٱلۡفُلۡكِ ٱلَّتِي تَجۡرِي فِي ٱلۡبَحۡرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ ومَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٖ فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا وبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٖ وتَصۡرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وٱلسَّحَابِ ٱلۡمُسَخَّرِ بَيۡنَ ٱلسَّمَآءِ وٱلۡأَرۡضِ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ ﴾[iii].
- وعن ابن عباس قال: «جاءَ أَعرَابي إِلى النبيّ (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رَسول الله علمني من غرَائب العلم، قال (صلى الله عليه وآله): ما صنعت في رَأس العلم حتى تسأَل عن غرَائبه؟ قال الرَّجل: ما رَأس العلم يا رَسول الله؟ قال (صلى الله عليه وآله): معرِفةُ الله حق معرِفته، قال الأَعرَابي: وما معرِفةُ الله حق معرِفته؟ قال: تعرِفه بلا مثل ولا شبه ولا ندٍّ وأَنه واحدٌ أَحدٌ ظاهرٌ باطنٌ أَوَّلُ آخرُ لا كفوَ له ولا نظيرَ، فذَلك حقّ معرِفته»[iv].
- عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «ما أَقبح بالرَّجل يأتي عليه سبعون سنةً أَو ثمانون سنةً يعيش في ملك الله ويأكل من نعمه، ثمّ لا يعرِف اللهَ حقَّ معرِفته»[v].
دراسة العقيدة
تحظى دراسة العقيدة بأهمّيّة فائقة ويتّضح ذلك بملاحظة النقاط الآتية:
النقطة الأولى: لسدّ حاجة فطريّة متأصّلة في وجود الإنسان، وهي غريزة حبّ الاطّلاع، فالطفل عندما يسمع صوتًا أو يلمس شيئًا يحاول أن يعرف مصدر ذاك الصوت أو ماهية هذا الشيء، ويبقى يبحث ويتلفت ولا يهدأ إلّا عندما يعرف مصدره وحقيقته. وهكذا وجود الإنسان والعالم وما فيه من موجودات وعجائب، كلّ ذلك يدفع الإنسان للبحث عن خالقها وكيف وجدت وما الغاية من وجودها.
النقطة الثانية: لتأثير العقيدة الكبير على سلوك الإنسان في مجمل حياته؛ لأنّ العقيدة ليست فكرة مجرّدة، بل هي فكرة ذات أثر عمليّ ينعكس على سلوك الإنسان وأخلاقه وتصرّفاته بل تنعكس في شكله الظاهريّ، فالمؤمن بالله الملتزم تختلف حياته وسلوكه ومظهره عن غيره وما ذلك إلّا بتأثير من عقيدته والتزامه.
النقطة الثالثة: لمعرفة الحقّ من العقائد الكثيرة المنتشرة بين البشر، إذ لا يمكن الأخذ بها جميعًا؛ لأنّها متناقضة ومتعارضة فيما بينها، وإذا أراد أن يأخذ بواحدة منها فلا بدّ أن يكون ذلك على أساس، وليس هو إلّا الدليل والمنطق. ومن هنا احتيج إلى الدراسة والتحقيق لتعرف العقيدة التي تستند إلى الدليل والبرهان ليأخذ بها ويترك ما سواها.
وقد تسأل: نحن نعتنق الإسلام ونتبع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) وجازمون ببطلان ما عدا ذلك من الأديان والعقائد، فهل نحتاج إلى البحث والدراسة أيضًا؟
الجواب: نعم، نحتاج إلى ذلك لتكون عقيدتنا عن فهم وبصيرة ولنتعرف على شبهات المنحرفين ومغالطاتهم وكيفية ردّها ولتكون عندنا القدرة على نشر الإسلام والدعوة إليه، والدفاع عنه.
أصول الدين
الدين: هو الرسالة النازلة من الله سبحانه وتعالى لتنظيم حياة الإنسان في مجالاتها المختلفة، بما يحقّق له السعادة في الدنيا والآخرة.
وأصول الدين: هي أسس الدين وقواعده التي يقوم عليها، وهي ثلاثة: التوحيد، النبوّة، المعاد، وما يتفرّع عنها، وهذه الثلاثة تعدّ أسسَ الإسلام، فمن يعتقد بها يعدّ مسلمًا ومن لا يعتقد بها أو بأحدها لا يكون داخلًا في ملّة الإسلام، قال تعالى في كتابه الكريم: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ ورَسُولِهِۦ وٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِن قَبۡلُۚ ومَن يَكۡفُرۡ بِٱللَّهِ ومَلَٰٓئِكَتِهِۦ وكُتُبِهِۦ ورُسُلِهِۦ وٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ﴾[vi].
فروع الدين
هي مجموع التعاليم والأحكام التي تنظّم حياة الإنسان في مجالاتها المختلفة الشخصيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة وغيرها وهي عشرة: الصلاة، والزكاة، والخمس، والصوم، والحجّ، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والولاية لأولياء الله، والبراءة من أعدائهم.
أصول المذهب
يتفرّع عن مبحث التوحيد الذي هو الأصل الأوّل في الدين مبحث العدل، ونظرًا لأهمّيّة هذا المبحث وما يترتّب عليه من آثار اجتماعيّة عدّته مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) أصلًا من أصول الدين، كما تفرّع عن أصل النبوّة مبحث الإمامة، وهو من المباحث المهمّة، وفي ضوئه انقسم المسلمون إلى سنّة وشيعة، فالشيعة يعتقدون بأنّ الإمامة امتداد للنبوّة وهي ثابتة بالنص، وبذلك تكون أصول الدين عند الشيعة خمسة: التوحيد، والعدل، والنبوّة، والإمامة، والمعاد.
ومن لا يعتقد بالعدل والإمامة كأصل من أصول الدين فهو مسلم، ولكنّه ليس شيعيًّا، وكلّ مسلم دمُه ومالُه وعرضُه حرام من أيّ مذهب كان.
وجوب التصديق بأصول العقيدة
لا بدّ من تحصيل اليقين الجازم بأصول العقيدة من خلال البحث والتحقيق والنظر والتفكير؛ لأنّ العقيدة تمثّل القاعدة الأساس في وجود الإنسان، ولذا لا بدَّ أن تكون قويّةً راسخة، كما أنّ الآيات الشريفة أكّدت على ذلك ونهت عن العمل بالظنّ؛ قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وٱلۡبَصَرَ وٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسُۡٔولٗا ﴾[vii].
وقال تعالى: ﴿ وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ ﴾[viii]، ولذا أجمع العلماء على وجوب تحصيل العلم واليقين بالعقيدة، والواجب هو تحصيل المعرفة الإجماليّة لا التفصيليّة، وهي تتأتّى بأدنى التفات وتفكير؛ لكون العقيدة الإسلاميّة مطابقة للفطرة السليمة نظير استدلال الأعرابيّ الذي سئل عن ربّه فقال: «البعرة تدلّ على البعير، وأثر الأقدام على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا يدلّان على اللطيف الخبير»[ix]، وهذا المقدار من الدليل ميسور لأغلب الناس، ولذا يقبل الإسلام بمجرّد الإقرار بالشهادتين. ويؤيّد ذلك ما جاء عن الإمام الباقر (عليه السلام): «إنّ الله بعث محمدًّا (صلى الله عليه وآله) وهو بمكّة عشر سنين، فلم يمت بمكّة أحد في تلك العشر سنين يشهد أن لا إله إلا اللّه وأنّ محمدًا رسول الله إلّا دخل الجنّة بإقراره»[x].
وكان النبيّ (صلى الله عليه وآله) يقول: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»[xi]، فلم يطلب منهم شيئًا غير الإقرار بوحدانيّته تعالى[xii].
أهمّيّة العقل
اهتمّت الشريعة المقدّسة بالعقل اهتمامًا بالغًا فهو أعظم هبة وهبها الله للإنسان، وبه كرّم وامتاز عن غيره من سائر الحيوانات، وقد ذُكر في القرآن الكريم أكثر من سبعين مرّة، منها:
1- قوله تعالى: ﴿ أَفَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَتَكُونَ لَهُمۡ قُلُوبٞ يَعۡقِلُونَ بِهَآ أَوۡ ءَاذَانٞ يَسۡمَعُونَ بِهَاۖ فَإِنَّهَا لَا تَعۡمَى ٱلۡأَبۡصَٰرُ ولَٰكِن تَعۡمَى ٱلۡقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾[xiii].
2- قوله تعالى: ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلۡبُكۡمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡقِلُونَ ﴾[xiv].
3- قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوۡ كُنَّا نَسۡمَعُ أَوۡ نَعۡقِلُ مَا كُنَّا فِيٓ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾[xv].
هذه الآيات وغيرها الكثير تدعو إلى التعقّل وتمدح المتعقّلين وتذمّ الذين لا يستفيدون من عقولهم وتنعتهم بأسوأ النعوت، وهكذا الحال في السنّة الشريفة حيث جاءت فيها الأحاديث الكثيرة التي تبين أهمّيّة العقل، منها:
1- ما ورد عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: «لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أَقبل فأَقبل، ثم قال له: أَدبر فأَدبرَ، ثم قال: وعزَّتي وجلالي ما خلقت خلقًا هوَ أَحب إِلي منك ولا أَكملتك إِلا فيمن أُحب أَما إِني إِياك آمرُ وإِياك أَنهى وإِيّاك أُعاقب وإِيّاك أُثيب»[xvi].
2- عن الإمام الرضا (عليه السلام) وقد ذُكر عنده العقل فقال: «لا يعبأُ بأَهل الدِّين ممن لا عقل له، قلت: جعلت فدَاك إِن ممّن يصف هذَا الأَمرَ قومًا لا بأس بهم عندَنا وليست لهم تلك العقول؟ فقال (عليه السلام): ليس هؤُلاءِ ممّن خاطب الله، إِن الله خلق العقل فقال له: أَقبل فأَقبل، وقال له أَدبر فأَدبرَ، فقال: وعزَّتي وجلالي ما خلقت شيئًا أَحسن منك أَو أَحبَّ إِليَّ منك بك آخذُ وبك أُعطي»[xvii].
العقل الحجّة الكبرى
الحجج التي يحتجّ بها الله سبحانه وتعالى على العباد كثيرة جدًّا، وبالتحليل ترجع كلّها إلى حجّتين: حجّة باطنة وهي العقل، وحجّة ظاهرة وهم الأنبياء (عليهم السلام) الذين أرسلهم الله تعالى لهداية البشر وجعلهم سفراء بينه وبين خلقه، ولكن العقل يعدّ الحجة الكبرى، ويتّضح ذلك من خلال النقاط الآتية:
النقطة الأولى: العقل حجّة على كلّ البشر مهما كانوا وأينما وجدوا صغارًا أم كبارًا ذكورًا أم إناثًا، متعلّمين أم غير متعلّمين، وأمّا الأنبياء فحجّتهم خاصّة بمن وصلت إليهم دعوتهم، فمن لم يؤمن بالإسلام لكونه في مكان ناءٍ ولم يطّلع على دعوة النبيّ يكون معذورًا.
النقطة الثانية: بالعقل يثبت صدق الرسول وصحّة دعواه للنبوّة، ولولا العقل لما أمكننا إثبات صدق الرسول وصحّة الرسالة.
النقطة الثالثة: حجّيّة العقل ذاتيّة، أي: غير مكتسبة يدركها الإنسان بذاته فلا يعتريها شكّ أو شبهة، بخلاف الوحي فإنّ حجّيّته مكتسبة من العقل.
وجود الله سبحانه وتعالى
الأدلّة على وجود الله سبحانه وتعالى كثيرة ومتنوّعة وبكافّة الأشكال والمستويات، فلا توجد حقيقة في عالم الوجود أوضح من حقيقة وجود الله الواحد الأحد:
وَفِي كُلِّ شَيءٍ لَهُ آَيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ واحِدُ
ونتناول فيما يلي اثنين من الأدلة:
الدليل الأوّل: دليل الفطرة
الفطرة: هي الخلقة، والأمور الفطريّة هي الأمور التي تقتضيها خلقة الإنسان لو خُلّي وطبعه من دون مانع، فإذا قيل الصدق فطريّ فمعناه أن الإنسان لو خلي وطبعه يحب الصدق، وهكذا عندما يقال: الظلم قبيح بالفطرة، فمعناه أن الإنسان بطبعه يكره الظلم ويستقبحه، والأمور الفطرية التي أودعها الله تعالى في صميم ذات الإنسان قد تدوم فيه كما هو الغالب، وقد تزول أو تضعف بسبب التربية السيئة أو العادات القبيحة أو نحو ذلك، ولذا قيل: «الأمورُ الفطريّة أمور اقتضائيّة»، وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ما من مولودٍ يولدُ إِلاَّ على الفطرَةِ فأَبوَاه يُهوِّدَانِه أو يُنصّرَانِه أو يُمجّسانِه»[xviii]، أي يخرجانه عن فطرته بتربيتهم السيئة.
والمقصود من الدليل الفطريّ هو أنّ الإنسان بمقتضى خلقته يعرف الله، ويعتقد به، ويحبّه، ويلجأ اليه في الملمّات، ويأنس بذكره، وإن كان كثيرًا من الناس بسبب انغماسهم في الشهوات، وتعلّقهم بالأسباب يغفلون عن ربّ الأسباب، ولذا عندما يقع الإنسان في ورطة ويشعر بعجزه وحاجته كما يحصل ذلك في حالات الخوف والشعور بالخطر، يلتفت إلى خالقه ويتوجّه إليه بكلّ قوّةٍ طالبًا منه العون والمساعدة، قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وٱلۡبَحۡرِۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمۡ فِي ٱلۡفُلۡكِ وجَرَيۡنَ بِهِم بِرِيحٖ طَيِّبَةٖ وفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتۡهَا رِيحٌ عَاصِفٞ وجَآءَهُمُ ٱلۡمَوۡجُ مِن كُلِّ مَكَانٖ وظَنُّوٓاْ أَنَّهُمۡ أُحِيطَ بِهِمۡ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنۡ أَنجَيۡتَنَا مِنۡ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴾[xix].
وقد اعتمد الإمام الصادق (عليه السلام) على هذا الدليل في جواب من سأله عن الله سبحانه وتعالى، فقال له: «يا عبدَ الله هل رَكبت سفينةً قط؟ قال: نعم، قال: فهل كسرَ بك حيث لا سفينةَ تنجيك ولا سباحةَ تغنيك؟ قال: نعم، قال: فهل تعلّق قلبُك هنالِك أَنّ شيئًا من الأَشياءِ قادِرٌ على أَن يخلّصك من ورطتك؟ فقال: نعم، قال الصادِق (عليه السلام): فذَلك الشيءُ هوَ الله القادِرُ على الإِنجاءِ حيث لا منجي وعلى الإِغاثةِ حيث لا مُغيث»[xx].
وفي حديث عن النبي ﷺ: «كل موْلودٍ يولدُ على الفطرَةِ يعني على المعرِفةِ بأَنّ الله خالقه فذَلك قوله: ﴿ وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وٱلۡأَرۡضَ وسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وٱلۡقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۖ فَأَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ ﴾[xxi]»[xxii]. وهذا هو أهم وأفضل دليل على وجود الله سبحانه وتعالى.
خواصّ الأمور الفطريّة
1- عامّة لدى كلّ البشر في جميع الأمكنة والأزمنة.
2- لا تحتاج إلى تعليم وتعلّم.
3- العمل بها يوجب الشعور بالطمأنينة والسعادة.
4- قد تضعف أو تخبو لمدّة، ولكن ما تلبث أن تظهر وبكلّ قوّة.
الدليل الثاني: دليل البداهة
المقصود من دليل البداهة هو وضوح وجوده سبحانه وتعالى بحيث يدركه كلّ إنسان بأدنى التفات؛ لأنّ وجوده تعالى من القضايا البديهية التي قياساتها معها من قبيل الواحد نصف الاثنين، والكلّ أكبر من الجزء، بل هو من أظهرها، ولذا ورد الاستنكار على من يشكك في وجوده تعالى في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: ﴿ أَفِي ٱللَّهِ شَكّٞ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وٱلۡأَرۡضِۖ ﴾[xxiii]، قال السبزواري! في منظومته[xxiv]:
وُجُودُهُ مِن أَظهَرِ الأَشيَاء وَكُنهُهُ فِي غَايَةِ الخَفَاء
وفي دعاء الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة: «كيف يستدَل عليك بما هوَ في وُجودِه مفتقرٌ إِليك؟ أَيكون لغيرِك من الظهورِ ما ليس لك حتى يكون هوَ المظهرَ لك؟ متى غبت حتى تحتاج إِلى دَليل يدُلّ عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثارُ هي التي توصل إِليك؟ عميت عين لا ترَاك عليها رَقيبًا، وخسرَت صفقةُ عبدٍ لم تجعل له من حبّك نصيبًا»[xxv].
وبالرغم من بداهة وجود الله سبحانه وتعالى ووضوحه وفطرية معرفته تتوفر أدلة عقلية وعلمية لا عدّ لها ولا حدّ على إثبات وجوده سبحانه وتعالى بحيث لا يبقى أي عذر لمن ينكر وجوده تعالى؛ لأنه ثابت بالفطرة وببداهة العقل وبالأدلة العقليّة والعلميّة المحكمة.
الإيمان بالخالق وأثره على الإنسان
الإنسان المؤمن يعيش حالة من السكينة والاطمئنان وراحة البال وترتبط درجة ذلك بدرجة إيمانه، فكلّما ازداد إيمانه ازدادت ثقته وطمأنينته؛ لأنّه يعتقد بأنّه مرتبط بخالق الكون الذي بيده كلّ شيء وهو رؤوف رحيم بعباده خبير بصير بهم، وأنّ كلّ شيء يجري بأمره، قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وتَطۡمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكۡرِ ٱللَّهِۗ أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ ﴾[xxvi].
فمثل هذا الإنسان لا يصيبه يأس ولا ضعف ويكون كالجبل الراسي لا تؤثّر فيه الرياح العاصفة، وتأريخ المؤمنين على مر العصور يشهد على ذلك فقد تحدوا أعتى الطواغيت وهم لا يملكون شيئًا سوى إيمانهم بالله العزيز الحميد، فموسى (عليه السلام) وقف بوجه فرعون وجبروته، وإبراهيم الخليل (عليه السلام) حطم الأصنام ولم يصبه أي خوف وقد جمعوا له الحطب بكمّيّات كبيرة، حتى صار كالجبل ثم أُلقي فيه بالمنجنيق، ونبينا محمّد (صلى الله عليه وآله) وقف شامخًا بوجه قريش وجبروتها وخيلائها، وهكذا سائر المؤمنين على طول التأريخ.
فالإنسان إذا كان يحمل إيمانًا صحيحًا يدرك أن ليس في عالم الوجود ما يستحق الإجلال والتعظيم والخوف سوى الله تعالى: ﴿ أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبۡدَهُۥۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦۚ ﴾[xxvii].
أمّا الإنسان الفاقد للإيمان أو ضعيف الإيمان فتجده إنسانًا خاويًا خائفًا يصيبه اليأس والقنوط عندما يتعرض إلى أدنى مشكلة أو ابتلاء، وهذا هو السبب في ارتفاع معدلات الانتحار في الشعوب الغربية والبعيدة عن الله، حيث تطغى عليها النزعة المادية والدنيوية، وانتشار القلق والأمراض النفسية وحالات الاكتئاب فيها بشكل واسع؛ لأن مثل هذا الإنسان ليس له ارتباط إلا بالأسباب المادية، فإذا لم تكن مؤاتية له أو عاكسته، فقد الأمل، ولربما بادر بالانتحار ليضع حدًّا لعذابه، فمثل الإنسان الذي ليس له صلة بالله كريشة في مهبّ الريح أو قشة وسط الأمواج العاتية.
المنكرون لوجود الله سبحانه وتعالى
كان ولا يزال طائفة من البشر تنكر وجود الله سبحانه وتعالى، وربما تطغى في بعض الفترات موجة إلحاديّة، ولكنّها ما تلبث أن تنقشع وتزول.
وأهمّ ما استدلّ به المنكرون لوجود الله هو عدم إمكانيّة رؤيته، حيث قالوا: لو كان الله موجودًا لرأيناه بالعين المجرّدة وما دمنا لا نراه إذن هو غير موجود، أي: إنّهم حصروا الموجود بالمحسوس، فكلُّ ما لا يقع تحت الحسّ فهو غير موجود بنظرهم!
ودليلهم هذا مردودٌ بعدّة وجوه:
الوجه الأوّل: إنّ الذي يقع تحت الحسّ هو الموجود المادّيّ فقط، ولكنّ الموجود لا ينحصر بالموجود المادّيّ، فهناك موجودات غير مادّيّة، وهذه تدرك بالعقل ومن خلال آثارها، ومثال ذلك العقل نفسه، فممّا لا شكّ فيه أنّ الإنسان لديه عقل، ولكنّ العقل ليس جزءًا في بدن الإنسان كسائر الأجزاء؛ لأنّه غير مادّيّ، ولكن يعرف العاقل من غيره من خلال تصرّفاته، وهكذا الكهرباء، فهل الكهرباء يمكن أن يراها أحد؟ وهل هناك فرق بين السلك الذي تجري فيه الكهرباء من غيره؟ فكيف يحكم بوجود الكهرباء في هذا السلك دون غيره؟! فالحكم لا يكون إلّا من خلال ملاحظة آثاره، وهي الإضاءة والتسخين وصعق من يمسكه، وهكذا قوّة المغناطيس؛ فإنّها لا ترى بالعين وإنّما تعرف بآثارها.
فالحكم بوجود شيء أو عدمه لا ينحصر بوقوعه تحت الحس وعدمه، نعم، الوقوع تحت الحس أسلوب لإثبات وجود الأشياء المادية، لا أنه الأسلوب الوحيد لإثبات وجود الأشياء.
الوجه الثاني: لا يوجد دليل على نفي الموجود غير المحسوس؛ لأن الحس غاية ما يثبت هو عدم وقوع الشيء تحت الحس، وعدم وقوعه تحت الحس لا يعني أنه غير موجود؛ لأن عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود، فإنكار وجود الله سبحانه لا يستند إلى دليل.
الوجه الثالث: إنكار وجود الله تعالى الخالق المبدع يوقعنا في حيرة واضطراب نعجز معهما عن إعطاء تفسير مقنع للوجود، فضلًا عن مخالفته للفطرة ولتأريخ البشرية الذي يثبت أن الحالة العامة للبشرية في تأريخها الطويل، الإيمان بالله والارتباط به، فقد نجد كثيرًا من الناس وهم جهال أو أميون أو بعيدون عن الحضارة، ولكن قلما نجد أمة أو شعبًا ليس له ارتباط بالله سبحانه وتعالى.
وإن كانت البشريّة وقعت في مسيرتها بانحرافات فاتّخذت غير الله تعالى إلهًا، ولكن هذا الانحراف يؤكّد وجود الحاجة إلى المعبود. ومن هنا يُنقَل عن المؤرّخ الإغريقيّ بلوتارك قولُه: «لقد وجدت في التأريخ مدنًا بلا حصون، ومدنًا بلا قصور، ومدنًا بلا مدارس، ولكن لم توجد أبدًا مدن بلا معابد»[xxviii].
4ـ بحار الأنوار، العلّامة المجلسيّ 4: 54.
5ـ التوحيد، الشيخ الصدوق: 284.
9ـ بحار الأنوار، العلّامة المجلسيّ 66: 134.
10ـ الكافي، الشيخ الكلينيّ 2 : 27.
11ـ بحار الأنوار، العلّامة المجلسيّ 18 : 202.
12ـ راجع: التقليد في الفروع لا في الأصول في هذا الكتاب، ص78.
16ـ الكافي، الشيخ الكلينيّ 1: 10.
17ـ الكافي، الشيخ الكلينيّ 1: 28.
18ـ من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق 2: 49.
20ـ التوحيد، الشيخ الصدوق: 231.
22ـ التوحيد، الشيخ الصدوق: 330.
24ـ شرح المنظومة (تعليقات الشيخ حسن زاده) 2: 59.

